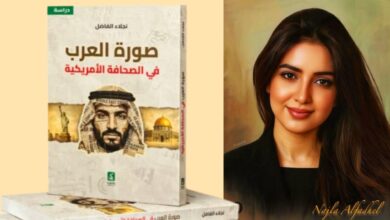الروائي “ذ.عبد السلام بو عسل”: الكتابة تمنح صاحبها سيطرة رمزية على الألم.

حاورته: الكاتبة و الإعلامية سلمى القندوسي
جريدة “تيلي ناظور” ترحب بالروائي عبد السلام بو عسل من مدينة ‘تطوان’ و تتشرف بكشف أسرار خطواته نحو نسج خيوط روايته الجديدة “رصيف الذاكرة” للجمهور و تمنح لهم فرصة الغوص معه في عالم يتقاطع فيه الماضي مع الحاضر و يجلس الكاتب ليحدثنا عن بطل ينهار كلما حاول أن يقف، و عن امرأة تتحوّل من ذكرى إلى لعنة، و عن مدينة تطن كجرس إنذار لا يتوقف.
رواية تنقل القارئ إلى عالم من الأسئلة: لماذا نعود لمن جرحنا؟ و هل الذاكرة نعمة أم عقاب؟ و هل الانهيار أحيانا جزء من النجاة؟
لنقترب أكثر من الأستاذ عبد السلام بو عسل الإنسان قبل الكاتب و نسافر معه إلى أماكن كتبت بملح التجربة و دمع الخيبة.
من هو عبد السلام بوعسل بعيدا عن الكتب؟ كيف يعرف نفسه للقراء بلغة بسيطة و صادقة؟
أنا رجل يسير بهدوء في دروب الحياة، يحمل في داخله أكثر مما يقول، و يبحث دائما عما يمنح روحه معنى، لست مجرد اسم على غلاف كتاب، و لا ساردا يختبئ خلف جمل منمقة، أنا ابن التفاصيل الصغيرة: رائحة القهوة في الصباح، صمت الليل حين يثقل القلب، وضحكة خفيفة تأتي في اللحظة التي كنت تظن فيها أن العالم كله يعاندك.
أكتب لأن الكتابة تخلصني من ازدحام المشاعر، ولأنني حين أضع جملة على الورق أشعر بأن جزءا مني يصبح أكثر وضوحا. أحبّ الناس البسطاء، المحادثات الصادقة، و الوجوه التي تقول الحقيقة قبل الكلمات، أنا شخص يؤمن بأن الإنسان أكبر من ماضيه، و أن الجراح، مهما طال ألمها، تصبح في النهاية نافذة يدخل منها الضوء. إن كنت أقدم شيئًا للقراء، فهو كلمة تمس القلب قبل العقل، وتقول لهم: “لسنا وحدنا في هذا العالم، نتشابه أكثر مما نظن.”
أستاذ عبد السلام، بما أنك تعتبر “رصيف الذاكرة” باكورة الأعمال السردية لك و مفتاح دخول عوالمك الإبداعية الأولى، ما اللحظة التي اكتشف فيها أن الكتابة ليست هواية فقط، بل مصير لا يمكن الهروب منه؟
اكتشفت أن الكتابة ليست هواية حين أدركت أنني لا أستطيع أن أهرب منها، كانت هناك ليلة مليئة بالحزن و الألم، هادئة أكثر مما ينبغي، و قلقة أكثر مما أحتمل. حاولت أن أنام، أن أُسكت ذلك اليأس الداخلي الذي لا يعرف موعدا، لكن الكلمات كانت تطاردني مثل ظل يرفض أن يغادر.
يومها فهمت شيئا عميقا هو أن الكتابة ليست خيارا أتسلّى به، بل حاجة تشبه التنفس. أنني لو تركت القلم، ستظل الحكايات تتكدس في صدري حتى تثقلني. الكتابة لم تعد مجرد فعل… صارت طريقة لفهم العالم، ولإنقاذ نفسي منه أحيانا. لحظتها وجدتني أكتب لأني لا أملك سوى أن أكتب، وعرفت أن الطريق قد اختارني قبل أن أختاره.
هل تحمل “رصيف الذاكرة” شيئاً من تجربتك الشخصية، أم أنها مجرد مرايا تعكس وجوه الناس حولك؟
رصيف الذاكرة ليست سيرةً مكتوبة، لكنها أيضا ليست خيالا بريئا تماما. هي مثل مرآة مكسورة، كل شظية منها تلتقط جزءا من وجه ما… أحيانا وجهي، وأحيانا وجوه الذين مروا في حياتي ثم غابوا، أو الذين تركوا أثرا لا يمحى.
هناك مشاهد ولدت من تجربتي الشخصية، لكنني لا أقدمها كما هي، أتركها تعبر إلى الورق بعد أن يغيرها الزمن ويعيد تشكيلها في مخيلتي، وهناك صفحات أخرى لم أعشها أنا، بل سمعتها من نبض الآخرين: من صمت صديق، من حزن عابر في عين غريب، من حكاية توقفت عند نصفها وظلت تبحث عن نهاية.
لذلك يمكنني القول إن الرواية ليست انعكاسا مباشرا لحياتي، وليست انعزالا عنها أيضا، إنها المكان الذي تلتقي فيه ذاكرتي بذاكرة الناس، والرصيف الذي يتقاطع عليه وجعي مع وجعهم، لنصنع معا حكاية لا تخص أحدا وحده… لكنها تمس كل من مر بالقرب.
أي الكتب أو الكتّاب تركوا أثراً في تكوينك الإبداعي؟ وكيف يظهر هذا الأثر في كتاباتك؟
هناك كتب لم تكن مجرد أوراق بالنسبة لي، كانت منارات، تأثّرت بعمق بالمنفلوطي ودفئه الإنساني، بقدرته على تحويل الحزن إلى لغة شفافة، ومن نجيب محفوظ أخذت دهشة التفاصيل، ذلك الفن العجيب في جعل الشارع شخصية حية، أحببت غسان كنفاني لأنه يكتب كما لو أن الجرح يفكر، ولأن كلماته تظل بعد أن تطوى الصفحات، وفي الأدب العالمي، كانت أعمال ماركيز ودوستويفسكي محطات فاصلة… الأول علمني سحر الواقع حين يختلط بالأسطورة، والثاني جعلني أرى الظلال في النفس البشرية بوضوحٍ مخيف.
كل هؤلاء تركوا أثرا ما… لكنه أثر لا يهيمن، بل يرافقني مثل نبرات خفية في الخلفية، ربما يلمس القارئ في أسلوبي ميلا للتفاصيل الهادئة، وللجمل التي تشبه البوح أكثر من التصريح… وربما يرى أثر الواقعية السحرية حين يتداخل الواقع بالمجاز دون ضجيج.
ومع ذلك، أحاول دائما ألا أكون نسخة من أحد. الكتابة رحلة للبحث عن صوتي الخاص… صوتي الذي يتشكل من كل هؤلاء، لكنه لا يشبه أحدا تماما.
ما أكثر شيء يخشاه عبد السلام بو عسل في الحياة؟ وما أكثر شيء يمنحه الطمأنينة؟
أخشى الأشياء التي لا ترى… تلك التي تنمو في الداخل بصمت. أخشى أن أفقد قدرتي على الدهشة، أن أصبح شخصا يمر على الحياة كأنها طريق سريع بلا مناظر. أخشى أن ينطفئ في قلبي ذلك الضوء الصغير الذي يجعلني أكتب، أرسم، وأحلم. أخشى أيضا فقدان الناس الذين يمنحون لوجودي معنى، أن أصحو يوما فأجد المقاعد الخالية أكثر من الحاضرة.
أما الخوف الأكبر… فهو أن أعيش بلا أثر، بلا كلمة تبقى بعد أن أغادر.
لكن رغم كل ذلك، هناك أشياء تمنحني الطمأنينة…تلك اللحظات البسيطة التي لا تحتاج إلى تفسير: فنجان قهوة في صباح هادئ، ورقة بيضاء تنتظرني، كتاب مفتوح على جملة تشبهني. يد صادقة تربت على كتفي، أو دعاء يصلني من بعيد دون أن أعرف مصدره.
يمنحني الطمأنينة الإيمان بأن الحياة، مهما ضاقت، تخبئ لنا دوما نافذة صغيرة نطل منها على ما هو أجمل. وأطمئن كثيرا حين أكتب… كأن الكلمات ترتب فوضاي الداخلية وتهمس لي: ما دمت قادرا على التعبير، فأنت بخير.
كيف يتعامل مع الفشل أو الخيبة؟ وهل يعتبر الكتابة نوعاً من العلاج الذاتي؟
الفشل والخيبة ليسا غرباء عني… أعرفهما كما يعرف المسافر طرقا كثيرة قبل أن يجد طريقه. حين تأتي الخيبة، لا أتصرف كمن يريد أن ينتصر عليها فورا، أتركها تجلس أمامي قليلا، نتبادل الصمت، ثم أبحث عن المعنى الذي تخبئه، الفشل بالنسبة لي ليس سقوطا، بل علامة تقول: هذا الطريق ليس لك… جرب طريقا آخر، أو أعد السير بخطوات مختلفة.
نعم، أتألم، لكنني لا أرى في الألم عيبا، بل جزءا من إنسانيتي، أما الكتابة فهي علاجي الذي لم أطلبه لكنه وجدني، أكتب حين تتكدس المشاعر، حين أشعر بثقل لا يعرفه أحد، كل جملة أُسطرها تشبه تنفسا أعمق، وكل صفحة تعيد ترتيب فوضى كنت أظنها ستبتلعني، الكتابة لا تلغي خيباتي، لكنها تمنحها معنى. ولا تمحو الألم، لكنها تجعله أقل وحد، فحين أكتب، أشعر أنني أستعيد نفسي من يد كل ما حاول أن يخذلني.
ما السر الذي يحتفظ به الكاتب في درج قلبه ولم يبح به في كتاباته بعد؟
في درج قلبي سر ما زلت أحتفظ به كما يحتفظ طفل بحجر عثر عليه قرب البحر… لا يعرف لماذا أخذه، لكنه يشعر أنه يخصه وحده، هناك شيء لم أكتبه بعد، ليس لأنه لا يستحق الكتابة، بل لأنه أثمن من أن أضعه تحت ضوء الآخرين، ربما هو وجه قديم ما زال يرافقني، أو جرح لم يندمل بعد، أو حلم أخاف أن أكتبه فينكسر، كل كاتب لديه صفحة بيضاء يخشاها، لأنها لو كتبت ستكشف أكثر مما يحتمل.
والحقيقي أنني ما زلت أنتظر تلك اللحظة التي أجرؤ فيها على كتابة ذلك الذي يوجعني أكثر مما يلهمني… اللحظة التي أفتح فيها الدرج تماما دون خوف، وأترك قلبي يكتب دون أن يحسب خسائره.
إلى أن تأتي تلك اللحظة، سيظل السر محفوظا هناك…في الدرج الذي لا يفتح إلا من الداخل.
هل ترى نفسك كاتبا ملتزما، أم أنّك تكتب فقط حين يشتد عليك الوجع؟
لا أستطيع أن أسمي نفسي كاتبا ملتزما بالمعنى التقليدي… لست ذلك الرجل الذي يجلس إلى مكتبه في موعد ثابت، يكتب لأن الوقت حان. أكتب حين تستفزني فكرة، حين يوقظني صوت داخلي لا أستطيع إسكاته، وحين يشتد الوجع لدرجة يصبح معها الصمت أثقل من الكلام.
لكني أيضا لست كاتبا موسميا. قد لا أكتب كل يوم، لكنني أفكر في الكتابة كل يوم، كلمة تسحب كلمة، وذكرى تستدعي أخرى، وجملة تلمع في رأسي كما لو أنها تنتظر لحظة خلاص، الالتزام بالنسبة لي ليس التزام المواعيد… بل التزام الصدق… أكتب لأن الكتابة هي طريقتي الوحيدة لفهم نفسي، ولترميم ما تصدع بها دون أن يشعر أحد.
“إذًا… أكتب حين يشتدّ الوجع، وأكتب لأن الكتابة قدر لا يمكن الهروب منه. أنا كاتب حين أتألم، وحين أفرح، وحين أرتب حياتي على الورق حتى أفهمها أكثر.
الكتابة ليست واجبا… إنها نبضي حين يضطرب، وطمأنينتي حين أعود إلى نفسي.
كيف تتفاعل مع القراء؟ وما هي أجمل رسالة وصلتك يوما؟
أتفاعل مع قرائي وكأنني أفتح نافذة للمرة الأولى على عالم لم أعرفه بعد، رغم أنني كتبت من قبل على الفضاء الأزرق، ولدي إنتاجات تنتظر أن ترى الضوء خارج أدراجي.
هذه هي المرة الأولى التي تصل فيها كتاباتي إلى أيدي الآخرين، لذلك كل تعليق، كل رسالة، تبدو لي أكثر حميمية وأعمق أثرا، أشعر أن كل قارئ يشارك معي لحظة خاصة، وكأنه يدخل إلى رصيف ذكرياتي، ويقرأ بين السطور ما لم أستطع قوله بصوتي.
ما الذي تعد به قراءك في القادم من أعمالك؟
أعد قرائي بأن القادم سيكون رحلة أعمق في العاطفة والإنسانية، سأواصل البحث عن الكلمات التي تلمس القلوب وتثير التأمل، سأحاول أن أصنع شخصيات أكثر تعقيدا وحكايات أقرب إلى واقعنا، لكن بروح خيالية تجعل القارئ يرى ما وراء الأحداث اليومية.
أعدهم أيضا بالصدق في التعبير، بالكتابة التي تأتي من الداخل قبل أن تصل إلى الورق، وبأن تبقى كل رواية تجربة مشتركة بيني وبينهم، حيث يجدون في كلماتي صدى لمشاعرهم وتأكيدا على أن الحياة، رغم صعوباتها، تحمل دوما لحظات تستحق التأمل.
كيف ولدت فكرة “رصيف الذاكرة”؟ وهل كانت في الأصل قصة قصيرة أم وجعا توسع حتى صار رواية؟
ولدت فكرة رصيف الذاكرة من مشهد بسيط، من لحظة شعرت فيها أن الذاكرة تشبه رصيفا ننتظر عنده ما قد يأتينا من الماضي والحاضر، لم تكن في البداية أكثر من فكرة قصيرة منبثقة عن وجع صغير في القلب. لكنها بقيت تنمو بداخلي، تتسع مع كل ذكرى، مع كل تجربة، ومع كل شعور حاولت أن أفهمه، شيئًا فشيئا صار هذا الوجع حكاية أوسع، وصار يصرخ عاليا أن يتحول إلى رواية، كي يجد للذكريات والصمت والألم مكانا يروى فيه، وليصبح المطر والرصيف والشخصيات شاهدة على رحلة الإنسان في البحث عن ذاته.
الرواية تتناول الحب والخيبة والانكسار… ما الذي أردت قوله للقارئ من خلال هذا الصراع الداخلي للبطل؟
من خلال الحب والخيبة والانكسار الذي يعيشه بطل الرواية، أردت أن أُري القارئ عمق التجربة الإنسانية، كيف يكون الفرح حقيقيا حين يعرف الإنسان طعم الخيبة، وكيف تصبح الجراح جزءا من نضجنا ونمونا. أردت أن أقول إن الألم ليس نهاية الطريق، بل فرصة لاكتشاف الذات وفهم الآخرين، وأن الانكسار قد يكون بداية لإعادة البناء.
في النهاية، الصراع الداخلي للبطل ليس مجرد حكاية شخصية، بل انعكاس لكل لحظة ضعف وقوة يمر بها أي إنسان يبحث عن ذاته في مواجهة الحياة.
نوال، هل هي شخصية أم رمز؟ وهل تمثّل امرأة واحدة أم جيلاً كاملاً فقد توازنه العاطفي؟
نوال في رصيف الذاكرة ليست مجرد شخصية بعينها، بل رمز لما يعيشه الكثيرون من خيبة وانكسار، هي شخصية تحمل تفاصيل امرأة محددة، لكن في الوقت نفسه تمثل جيلا كاملا فقد توازنه العاطفي، امرأة تبحث عن نفسها في مواجهة الحب والألم والخسارة.
نوال إذا تجمع بين الفردي والرمزي، بين تجربة شخصية دقيقة، وبين صدى جماعي لمشاعر النساء اللواتي حاولن تحقيق التوازن بين القلب والعقل، بين الرغبة والانكسار، لتصبح بذلك شخصية قادرة على لمس كل قارئ يعرف معنى الحب والخسارة.
المكان، تطوان والمضيق ومقهى مانيلا، يبدو بطلا إضافيا في الرواية، لماذا هذا الارتباط القوي بالمكان؟
في رصيف الذاكرة، المكان ليس مجرد خلفية للأحداث، بل شريك فعال في الرواية، بل يمكن القول إنه بطل إضافي، تطوان والمضيق ومقهى مانيلا ليست أماكن جغرافية فقط، بل فضاءات تحمل الذكريات، والمشاعر، واللحظات التي كنت فضاءات خاصة بي للتفاعل والإنتاج، كل شارع، كل ركن، كل رائحة قهوة في المقهى ترتبط مباشرة بوجع أو فرح أو انتظار.
هذا الارتباط القوي بالمكان يمنح الرواية عمقا واقعيا، ويجعل القارئ يشعر وكأنه يمشي مع الشخصيات بين الأزقة، يسمع همس البحر، ويشم رائحة المطر على الأرصفة، المكان إذا يصبح شاهدا على الأحداث، ويعكس التحولات الداخلية للبطل، ويجعل التجربة أكثر حميمية وصدقا.
البطل يحاول الانتحار… لكنه يفشل، هل ترى أن الحياة تمنحنا دوما فرصة ثانية رغم الألم؟
نعم… أؤمن أن الحياة، مهما قست، تترك لنا دائمًا نافذة صغيرة مفتوحة، حتى لو لم نرها في اللحظة الأولى…محاولة البطل للانتحار ليست إعلانا عن النهاية، بل صرخة داخلية تقول إنه وصل إلى حد لم يعد يعرف فيه كيف يواجه الألم، لكن فشله في الانتحار لم يكن فشلا حقيقيا… كان شكلا من أشكال النجاة.
أردت أن أقول إن الحياة أحيانًا توقفنا عند الحافة لتختبر مدى رغبتنا في العودة، وأن الإنسان، رغم هشاشته، يملك قدرة خفية على التمسك بخيط رفيع من الأمل، حتى لو بدا ذلك الخيط غير مرئي.
في الرواية، كما في الواقع، ليست كل الفرص الثانية واضحة… بعضها يأتي في هيئة شخص، أو صدفة، أو كلمة تعيد ترتيب الفوضى بداخلنا. المهم أن ننتبه إليها حين تمر، لأن الألم مهما طال لا يمكنه أن ينتصر على رغبة الإنسان في أن يواصل، أن ينهض، وأن يجد ما يستحق الحياة من أجله.
الرواية غنية بالوصف النفسي واللغة الشعرية. هل تعمّدت أن تكون اللغة جزءاً من الحكاية وليس مجرد وسيلة؟
نعم، عمدت إلى أن تكون اللغة جزءًا من الحكاية، وليست مجرد أداة لنقل الأحداث، في رصيف الذاكرة، كل كلمة، كل جملة، تحمل إيقاعا ومزاجا يعكس الحالة النفسية للشخصيات، الوصف النفسي واللغة الشعرية ليسا زخرفا، بل وسيلة لتجربة المشاعر بشكل مباشر، كي يشعر القارئ بما يشعر به البطل، كي يرى العالم كما يراه، ويختبر ألمه وفرحه وحنينه وكأنهم يعيشونه معه. اللغة هنا تصبح مرآة للوجدان، وجسرا بين الواقع والخيال، وأداة لتمكين القارئ من الغوص في أعماق الحكاية، لا فقط لمتابعة ما يحدث، بل ليشارك البطل لحظاته الداخلية بكل صدق وعمق.
ما الرسالة الإنسانية التي تريد أن يخرج بها القارئ بعد إغلاق آخر صفحة؟
الرسالة الإنسانية التي آمل أن يحملها القارئ بعد إغلاق آخر صفحة هي أن الحياة، رغم الألم والانكسار، تستحق أن تعاش، أريد أن يدرك القارئ أن الحب والخيبة جزء من التجربة الإنسانية، وأن الألم ليس نهاية الطريق بل فرصة للنمو واكتشاف الذات، أن يعرف أن الانكسار قد يكون بداية لإعادة البناء، وأن الصبر والأمل، مهما كانا رفيعين، قادران على منحنا فرصة ثانية.
في النهاية، أرجو أن يغادر القارئ الرواية بقناعة بسيطة مفادها أننا لسنا وحدنا في وجعنا، وأن كل تجربة صعبة تحمل في طياتها بذور القوة والتجدد.
هل تعتقد أن القارئ سيجد نفسه في البطل، أم سيخاف أن يرى نفسه فيه؟
أظن أن القارئ سيجد في البطل جزءا من نفسه… أو ربما أجزاء كثيرة من ذاته لم يجرؤ على مواجهتها من قبل، بعضهم قد يشعر بالراحة في رؤية مشاعره وتجارب مشابهة منعكسة على صفحة الورق، بينما قد يخاف آخرون من مواجهة وجوه الخيبة والانكسار التي يعرفونها لكنه لم يجرؤ على الاعتراف بها.
البطل هنا مرآة… مرآة لا تكذب، لكنها لا تحكم أيضا، إنها تعكس الصراعات الداخلية، الحب والخسارة، الألم والأمل، لتدع القارئ يقرر إن كان سيقترب منها، أو يبتعد.
في النهاية، سواء وجد القارئ نفسه أم خافه، أملي أن التجربة ستمنحه فرصة للتأمل وفهم أعمق لما يحمله داخله.
ما أصعب مشهد كتبته في الرواية؟ وما أقرب مشهد إلى قلبك؟
أصعب مشهد كتبته في الرواية كان مشهد محاولة الانتحار للبطل، فقد تطلب مني الغوص في أعماق الألم واليأس، ومحاولة وصف شعور شخص يكاد يفقد كل شيء ولا يرى أمامه سوى الظلام، كان تحديا عاطفيا كبيرا، لأنني أردت أن يكون المشهد صادقا دون أن يتحول إلى مبالغة أو دراما مصطنعة.
أقرب مشهد إلى قلبي في الرواية هو حين جلس البطل مع حبيبته في رياض العشاق، لحظة هادئة تشع دفئا وسط صخب الحياة ووجع الذكريات، هناك بين ألوان الزهور وهمس النسيم، شعر البطل بالسلام الداخلي للحظة قصيرة، كأن العالم كله توقف ليستمع إلى نبض قلبيهما معا، هذا المشهد يجسد فكرة أساسية في الرواية: رغم الحب والخيبة والانكسار، تبقى هناك لحظات من الصفاء والدفء تمنح الإنسان القدرة على التمسك بالحياة واستعادة ذاته.
هل يمكن أن تتحوّل “رصيف الذاكرة” إلى عمل سينمائي أو مسلسل درامي؟ وكيف تتخيّل شكل هذا التحوّل؟
لست طموحا إلى هذا الحد، لكن أرى أن رصيف الذاكرة يمكن أن تتحول إلى عمل سينمائي أو مسلسل درامي، الأحداث غنية بالشخصيات والمشاهد، والمكان يكاد يصبح بطلا إضافيا.
أتخيل العمل يركز على التفاصيل الداخلية للبطل، على لغة الجسد ونبرة الصوت، وعلى الإضاءة والموسيقى التي تعكس المزاج النفسي للشخصيات، مع الحفاظ على الصدق والروح الشعرية للغة.
الفكرة ممكنة، لكنها ليست طموحي الأساسي، بل مجرد احتمال يسرني التفكير فيه.
لماذا اخترت مجموعة كلتورا الدولية لنشر هذا العمل تحديداً؟ وما الذي يميّزها بالنسبة لك؟
اخترت مجموعة كلتورا الدولية لنشر هذا العمل لأنها تمنح الكتاب مساحة للتعبير بحرية، وتقدّر الصدق والعمق في السرد، وهو ما شعرت به منذ أول تواصل معهم.
ما يميزها بالنسبة لي هو التوازن بين الاحترافية والاهتمام الشخصي بكل عمل، فهم لا ينظرون إلى الرواية كمنتج تجاري فقط، بل كحكاية لها روحها ولها جمهورها المستحق. كما أن سمعتها في دعم الكتاب الجدد ونشر الأعمال التي تحمل بعدا إنسانيا جعلتني أشعر أن روايتي ستصل إلى القراء بالشكل الذي يستحقونه، وأن كلماتي ستجد صدى صادقا بين جمهور واسع.
كيف أسهمت دار النشر في إخراج الرواية بالشكل الذي رأيناه؟ وهل كان لها دور في تطوير النص أو صقله؟
أسهمت دار النشر بشكل كبير في إخراج الرواية بالشكل الذي نراه اليوم، من خلال الاهتمام بكل التفاصيل بدءا من التصميم والغلاف، مرورا بالتدقيق اللغوي والتحريري، وصولا إلى الطباعة وجودة المظهر العام، دعمهم هذا جعل الرواية تظهر بأفضل صورة ممكنة أمام القراء، مع الحفاظ على روح النص وأصالته.
ما الذي تقدّمه “كلتورا” للكاتب من دعم لا تجده في دور نشر أخرى؟
ما تقدمه كلتورا للكاتب ويجعلها مختلفة عن غيرها هو مزيج من الاحترافية والاهتمام الشخصي، فهي لا تقتصر على نشر الكتاب فقط، بل تراجع النص في كليته، وتقدم توجيها دقيقا مع احترام روح الكاتب وخصوصية عمله، وأصالة نصه.
هذا الدعم يجعل الكاتب يشعر أن روايته ليست مجرد منتج ينشر، بل تجربة كاملة يعتنى بها ليصل كتابه إلى القراء بأفضل صورة، مع الحفاظ على صدقه الفني والإنساني.
هل ترى أن العلاقة بين الكاتب ودار النشر ينبغي أن تكون شراكة إنسانية قبل أن تكون مهنية؟
نعم، أرى أن العلاقة بين الكاتب ودار النشر ينبغي أن تكون شراكة إنسانية قبل أن تكون مهنية.
فالمهنة مهمة، بلا شك، لضمان الجودة والاحترافية، لكن الدعم الحقيقي والإبداع لا يولدان إلا عندما يشعر الكاتب بالاحترام والتقدير لشخصه وعمله. الشراكة الإنسانية تخلق بيئة من الثقة، الحوار، والتفاهم، ما يسمح للنص بالنمو والتطور، ويجعل كل قرار نشر أو تعديل ينبع من التفاهم المشترك، لا مجرد التزام مهني.
كيف يرى الكاتب دور النشر في دعم الأدب المغربي والعربي اليوم؟ وهل قدمت كلتورا نموذجاً مختلفاً؟
دور الناشر في دعم الأدب المغربي والعربي اليوم محوري، فهي الجسر الذي يربط الكاتب بالقراء، وتمنحه مساحة ليبرز صوته وسط تدفق الأفكار والمواهب الجديدة، كثير من الدور تركز على الجانب التجاري أكثر من الإبداعي، وهذا قد يحرم بعض الأعمال من فرصة الانتشار.
أما كلتورا فقد قدمت نموذجا مختلفا، إذ توازن بين الاحترافية والاهتمام بالنص وروح الكاتب، فتدعم صقل الأسلوب، واحترام رؤية الكاتب، وتحرص على أن تصل الرواية إلى القارئ بأفضل صورة ممكنة. هذه الطريقة تجعلها شريكا حقيقيا في العملية الإبداعية، وليس مجرد وسيط نشر.
هل الرواية انتصار للذاكرة أم استسلام لها؟
في الحقيقة، رصيف الذاكرة ليست انتصارا خالصا ولا استسلاما كاملا، بل هي مواجهة مفتوحة بين الإنسان وذاكرته، الرواية تمنح الذاكرة فرصة لتقول ما لم يقل، وهذا في حد ذاته شكل من أشكال الانتصار، فهي تخرج التجارب المنسية من الظل إلى الضوء، وتعيد ترتيب اللحظات التي ظن القارئ أنها اندثرت.
لكن، في الوقت نفسه، لا تخفي الرواية أن الذاكرة قد تكون عبئا يجر الشخص إلى الخلف، الشخصيات تبدو أحيانا وكأنها مسيرة بقوة ما عاشته، لا قادرة على تجاوزه، وهو ما يوحي بأن هناك جانبا من الاستسلام لثقل الماضي.
لذلك يمكن القول إن رصيف الذاكرة رواية تقف في المنطقة الرمادية بين النقيضين: فهي تثبت أن تذكّر الماضي ضرورة لفهم الحاضر، لكنها تُظهر أيضًا أن الإفراط في التذكر قد يتحوّل إلى قيد خفي، إنها رواية تصالح القارئ مع ماضيه دون أن تدعي الانتصار عليه.
في رأيك، لماذا تلهمنا الخيبات أكثر مما يلهمنا النجاح؟
لأن الخيبة، في جوهرها، تجربة عميقة تهز الإنسان من الداخل وتجعله يعيد النظر في كل شيء، في اختياراته، في علاقاته، وحتى في رؤيته للعالم، فالنجاح يمنح لحظة بهجة، لكنه يمر سريعا، أما الخيبة فتبقى وتترك أثرا يفرض على الفرد أن يفكر، ويطرح الأسئلة ويبحث عن معنى أكبر.
ثم إن الخيبة تكشف هشاشتنا، وبهذا المعنى تقربنا من ذواتنا الحقيقية، فهي لحظة صدق قاسٍ، لكنها صادقة، ولهذا تلهم الكتابة والإبداع والسرد، لأنها تمنح المواد الخام التي تصنع منها الحكايات العميقة. أما النجاح فغالبا ما يعطينا شعورا بالاكتمال، وهذا لا يترك مساحة كبيرة للتأمل.
البطل يعيش عزلة خانقة… هل العزلة قدر الكاتب أم اختياره؟
العزلة التي يعيشها البطل ليست مجرد حالة نفسية طارئة، بل هي مرآة تعكس الوضع الوجودي للكاتب ذاته، كثيرون يرون أن العزلة قدرٌ يفرض نفسه على المبدع، لأنها تمنحه المسافة الضرورية لفهم العالم وإعادة تشكيله عبر الكتابة، غير أن هذا القدر في جوهره اختيار واع، فالكاتب ينسحب من ضوضاء الخارج ليمنح لغته فرصة أن تتنفس، وليصغي إلى ما لا يسمع عادة في صخب الحياة اليومية.
فالعزلة في الرواية تتأرجح بين القدر الذي يحاصر البطل من الخارج، والاختيار الذي يتخذه الكاتب من الداخل، إنها ليست انسحابا سلبيا، بل شرط لخلق عالم متخيل أكثر صدقا من العالم المعيش بذلك تبدو العزلة، مهما بدت خانقة، لحظة ولادة لا لحظة انطفاء.
هل يمكن أن نعتبر الرواية صرخة ضد المجتمع أم صرخة من داخله؟
الرواية ليست صرخة موجّهة ضد المجتمع بقدر ما هي صرخة صادرة من عمقه، فالكاتب لا يقف خارج المشهد ليدينه من عل، بل يتحرك من داخل النسيج الاجتماعي ذاته، كاشفا تشوهاته وتوتراته ومفارقاته، إن الألم الذي يصرخ به البطل هو جزء من الألم الجماعي، والاختناق الذي يعيشه لا ينفصل عن اختناق أكبر يحسه المجتمع كله، ولو بصمت.
لذلك فالرواية في جوهرها صرخة من الداخل، احتجاج ناعم أحيانا، جارح أحيانا أخرى، لكنه يظل محاولة لفهم المجتمع قبل محاكمته، ولتفكيك أسبابه العميقة بدل الاكتفاء بإدانة سطحه، إنها صرخة تحاول أن تعيد للإنسان صوته داخل منظومة كثيرا ما تتعمد إسكات الأفراد.
ما الذي كنت ستغيره في الرواية لو كنت ستكتبها اليوم من جديد؟
لو أعدت كتابة الرواية من جديد، فربما كنت سأغير زاوية النظر أكثر مما سأغير الأحداث، الزمن يعلمنا أن الحكايات هي نفسها، لكن كيفية روايتها تتبدل، كنت سأمنح بعض الشخصيات مساحة أوسع لتقول ما لم تستطع قوله في النسخة الأولى، وأترك للبطل لحظات صمت أطول تكشف هشاشته بدل أن تصفها فقط، وربما كنت سأخفف من حدة بعض المواقف، أو أزيد من حدة أخرى، تبعا لما اكتسبته من خبرة ووعي خلال الفترة اللاحقة لكتابة هذه الرواية.
ومع ذلك، أظن أنني كنت سأحتفظ بروح الرواية كما هي، فالكتابة تُشبه أثر الخطوة الأولى على الرمل، يمكن محوها، لكن لا يمكن إعادة تلك الخطوة بذات الشعور، ما يمكنني فعله فقط هو إعادة التأمل في العمل، لا إعادة خلقه بالكامل.
كيف يرى الكاتب دور الأدب في معالجة الاضطرابات النفسية والضغط الاجتماعي؟
أرى أن الأدب لا يقدم علاجا سريريا للاضطرابات النفسية، لكنه يمنح ما هو أعمق من ذلك، يمنح معنى، فالإنسان حين يقرأ أو يكتب يجد مساحة آمنة يضع فيها خوفه وقلقه وضغطه اليومي دون أن يحاسب، الأدب يحرر ما نخشى قوله، ويمنح مشاعرنا لغة تستطيع أن تقف على قدميها بدل أن تبقى عالقة في الداخل.
كما أن الأدب يخلق نوعا من التواطؤ الإنساني الجميل، فحين يشعر القارئ أن شخصا آخر، ولو كان بطلا متخيلا، يعيش ما يعيشه، ينكسر حاجز الوحدة النفسية، ومن هنا يصبح النص نافذة لفهم الذات والمجتمع معا، لأنه لا يكتفي بوصف الألم، بل يكشف أسبابه العميقة، ويضعه في سياق اجتماعي لا يمكن تجاهله.
لذلك، فدور الأدب في نظري هو أن يفتح مساحة وعي تتيح للإنسان أن يرى اضطرابه بوضوح، وأن يشعر بأن صوته مسموع، وأن يكتشف أن هشاشته ليست عيبا، بل جزءا من إنسانيته.
إلى أي مدى يستطيع القلم أن يداوي ما عجزت عنه الحياة؟
القلم لا يملك القدرة على تغيير الماضي أو محو الجراح التي خلفتها الحياة، لكنه يملك شيئا لا تملكه التجارب نفسها، قدرة إعادة المعنى، الذي تعجز الحياة عن مداواته بالقوة والوقائع، ينجح القلم أحيانا في مداواته بالكشف والتسمية والتفريغ، فالكتابة تمنح صاحبها سيطرة رمزية على الألم، تحول الجرح إلى نص، والصدفة القاسية إلى حكاية قابلة للفهم، والصمت الطويل إلى كلمات تستعيد توازنها على الورق.
وليس الشفاء هنا شفاء كاملا، بل تصالح هادئ مع ما حدث، فحين نكتب نصنع مسافة بيننا وبين الألم، ونمنحه شكلا نستطيع النظر إليه بدل أن يظل مختبئا في الداخل، لذلك يستطيع القلم أحيانا أن يقدم ما تعجز عنه الحياة، أن يعيد للإنسان صوته، وأن يجعل الوجع قابلا للتحمل، وربما قابلا للعبور.
نشكر الروائي المغربي، الأستاذ عبد السلام بوعسل، ابن مدينة تطوان، على صدق الكلمة، و أغتنم الفرصة لشكر “مؤسسة تيلي ناظور” على اهتمامها بالأدب و الثقافة، و نقول للجمهور، “تيلي ناظور” تجمعنا.